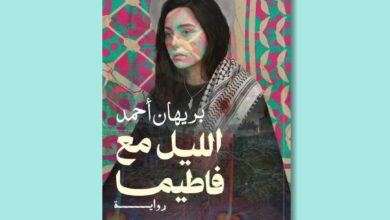د.عبير بسيوني تكتب : أمثلة لحالات قابلة للتسجيل كتراث ثقافي مصري مادي وغير مادي ضمن “علامة مصر”

من أهم وصايا العلامة المفكر الكبير ابراهيم شحاته-رحمه الله- في كتابه الموسوعي “وصيتي لبلادي” أن يتم وضع نصوص-بالدستور المصري- تتعلق بحماية الآثار التى خلفتها الحضارات المصرية عبر التاريخ وبحماية التراث الثقافي لمصر الذي يميزها عن معظم دول العالم الأخرى. هذا بالرغم مما تتعرض له هذه الأثار العظيمة، والتى تعتبر تراثا للإنسانية كلها من اعتداءات مستمرة. وحيث تحتاج الأثار المصرية المتعددة (بما فيها الآثار المصرية القديمة والآثار اليونانية والرومانية والقبطية والاسلامية) الي حماية مفصلة تكفل لها اكثر قدر من الحماية ويجعل من واجب الدولة والمواطنين المحافظة عليها للأجيال المقبلة
أولا: التراث المادي (الطبيعي والبيئي والصناعي والمائي)
مثال 1: ممر المدن المصرية الغارقة بحملة انقاذ “حضارة وتراث عالمي تحت الماء” لبناء أكبر متحف مائي مفتوح
نجح العالم في ستينات القرن الماضي في معجزة انتشال معبد متكامل، وكان شعار منظمة اليونسكو التى تبنت حملة ناجحة لانقاذ آثارنا في ابو سنبل “إن التراث العالمي هو فكرة بسيطة، ولكنها فكرة ثورية مفادها أن العالم يضم تراثاً ثقافياً وطبيعياً ذا قيمة عالمية ينبغي للبشرية حمايته بالكامل بوصفه إرثها الذي لا يتجزأ”.
واهتم العالم بالتراث المغمور بالمياه الذي يشتمل على المدن المغمورة وأطلال الحضارات القديمة وحطام السفن وكل ما هو تحت الماء وله قيمة ثقافية أو تاريخية. وصدقت مصر على عدة مواثيق دوليه اهمها عام ٢٠١٧ على اتفاقية اليونسكو لعام 2001 المعنية بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
والان التحدى أعظم لكشف أسرار التراث المغمور بإنشاء متحف/مركز متكامل بما في ذلك حديقة متحفية تحت المياه للآثار المغمورة بالمياه حازت اعتماد “اليونيسكو” ووزارة الآثار المصرية، لكن إجراءات التنفيذ كانت تتعطل بشكل مستمر لانقاذ الآثار الغارقة. ان ثروة مصر المطمورة في قلب المتوسط والكنوز الأثرية التى بقيت غير ملموسة تحت الماء لمدة تزيد عن 2400 عام في موقع مدينة “ثونيس-هرقليون” القديمة الغارقة ومدينة كانوبوس ومينوثيس بالقرب من أبو قير، الإسكندرية تحكي المزيد من حضارة مصر الفرعونية العريقة، خاصة قصة مدينتين فرعونيتين كانتا من أهم المدن القديمة التي غرقت تحت مياه البحر المتوسط بسبب زلزال مدمر ضرب مصر.
فكانت “كانوبيس” موقع المعابد المخصصة للإله أوزوريس، و”هرقليون” ميناء الدخول الرئيسي لمصر على البحر الأبيض المتوسط قبل تأسيس الإسكندرية على يد الاسكندر الأكبر في عام 331 قبل الميلاد، وتضم منطقة جنائزية يونانية تتضمن القرابين “الخزف اليوناني الفاخر المستورد”.
كما تضم سفينة من العصر البطلمي مغمورة تحت الماء غرقت بعد أن اصطدمت بها كتل ضخمة من معبد آمون الذي دُمّر في القرن الثاني قبل الميلاد نتيجة وقوع “حدث كارثي”، والأهم جزيرة أنتيرودس القديمة تحت الماء التى تم اكتشافها عام 1996 بالقرب من ميناء الإسكندرية على بعد أمتار قليلة تحت الماء، ويعتقد أنها غرقت بسبب الزلازل في القرن الرابع تقريبًا، فبالإضافة إلى كونها موقعًا لمنارة الإسكندرية(احدى عجائب العالم القديم)،وحيث يمكن تمييز أرضية رخامية من القرن الثالث قبل الميلاد، وقصر يعتقد أنه ينتمي إلى الملكة كليوباترا وكذلك قصرا للقائد مارك أنتوني،فضلا عن مجوهرات ومزهريات وحتى سفن الشحن القديمة، فضلا عن انه لا تتوقف الثروة المطمورة عند اثار العصور القديمة ولكنه يمتد لقطع بحرية تعود لنهاية القرن الـ18 عندما حاصر نيلسون أسطول نابليون في خليج أبوقير.
ويشير اتفاق “يونيسكو” في شأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي اعتمد عام 2001 إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، على أن يسمح بانتشال القطع عندما يكون التراث مهدداً بالتعرض للضرر أو الدمار أو عندما تسهم استعادته في حمايته من النهب أو التضرر.
تلى ذلك عام 2002 تقديم اليونسكو مشروعين بدعم منه لمتحفين تحت الماء(احدهما لمصر والثاني للصين) ونفذت الصين (متحف بايهيليانغ الصيني) 2009 وهو الأول من نوعه، إذ يسمح للزوار بالوصول إليه من دون الحاجة إلى الغوص، فقد أنشئ على سلسلة من التلال الحجرية تمكن للسائحين(من خلال 23 نافذة زجاجية مستديرة تحت الماء)رؤية النقوش والمنحوتات السمكية للصينيين القدماء.
ومع التقنيات الحديثة نتطلع لحملة عالمية من اليونسكو لتنفيذ مشروعه وتطويره بإقامة اول موقع تراث عالمي يشمل جزيرة أثرية متكاملة تنقلنا في العصور المختلفة المكتشفة وانشاء ممرات بمتحف مفتوح تحت الماء وهو جهد انساني ضخم لا يتوفر إلا بحملة عالمية لتنفيذ أفضل تصميم لهذا المزار المائي الضخم مع التوثيق الكامل لهذا الكنز الاثري وحمايته من السرقة بوضع كاميرات مراقبة تحت المياه وتغطية المواقع الأثرية المغمورة بشباك حديدية.
مثال 2 : تسجيل جبل كامل كمحمية طبيعية بالوادي الجديد
وسط صحراء مصر الغربية القاحلة، وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحدود السودانية والليبية، يقع موقع “جبل كامل”، أحد أندر المواقع الطبيعية على كوكب الأرض. وقصة هذا المكان تحمل في طياتها أسرارًا عن حدث كوني وقع منذ آلاف السنين، حين ارتطم نيزك عملاق بسطح الأرض، مخلفًا وراءه حفرة هائلة وآثارًا جيولوجية غنية لا تزال محط اهتمام العلماء والمستكشفين. فقبل نحو خمسة آلاف عام، وفي ظلام الكون الممتد، انطلق نيزك ضخم من منطقة الكويكبات بين كوكبي المشترى والمريخ بسرعة بلغت 12 ألف كيلومتر/الساعة. وتخطى النيزك مسافات لا تُحصى واخترق الغلاف الجوي للأرض، ليصل إلى نقطة ارتطام في قلب الصحراء الغربية، حيث جرى تكوين حفرة عملاقة تُعرف الآن باسم “فوهة كامل”، نسبةً إلى جبل كامل القريب منها.
ومع التطور التكنولوجي ثبت اكتشاف علمي يثبت ان خنجر توت من الحديد النيزكي. وقد ظل هذا الحدث طي الكتمان لآلاف السنين، إلى أن جاءت بعثة جيولوجية مصرية-إيطالية في عام 2010، قادت الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية عبر برنامج “جوجل إيرث” الباحث الإيطالي “فينتشنزو دي ميكيلي” لاكتشاف الفوهة لأول مرة، وبعد دراسات ميدانية، تأكد الفريق العلمي من وجود حفرة بقطر 45 مترًا وعمق 16 مترًا، تقع شرق العوينات وشمال شرق الوادي الجديد. وأظهرت الدراسات أن النيزك الذي أحدث هذه الفوهة كان يزن نحو 10 أطنان، ويتكون بنسبة 90% من الحديد و10% من النيكل، وهو ما جعله مصدرًا مهمًا لدراسة التكوينات المعدنية لكوكب الأرض والكواكب الأخرى. من بين الشظايا التي جرى العثور عليها، بلغ وزن أكبرها 83 كيلوجرامًا، وهي محفوظة الآن بالمتحف الجيولوجي المصري.
وفي 25 مارس 2012، أصدر رئيس الوزراء المصري قرارًا باعتبار المنطقة محمية طبيعية تحت مسمى “محمية نيزك جبل كامل“. وجاء هذا الإعلان تتويجًا للأبحاث العلمية التي أكدت أهمية المنطقة من الناحية الجيولوجية والبيئية، تقع المحمية على تكوينات الحجر الرملي التي تعود إلى العصر الطباشيري، وتُحيط بها جبال وأودية جافة من عصر ما قبل الكمبري، مما يجعلها موقعًا غنيًا بالدلالات التاريخية والطبيعية.
مثال 3: تسجيل أول تلفريك في مصر كـتراث صناعي وأثر تاريخي
طلب أهالي منطقة سرابيط الخادم بجنوب سيناء، تطوير منطقة المدينة الإنجليزية في قمة جبل أم بجمة كأول مدينة صناعية بناها الإنجليز من أجل استخراج الفيروز والمنجنيز، منذ أكثر من 150 سنة وتجذب السياح لمشاهدتها وتقوم عليها سياحة السفاري. وحيث يمكن ترميم هذه المدينة الصناعية العريقة وتحويلها لمنتجع سياحي فريد على قمة جبل أم بجمة يجذب السياح علاوة على إصلاح باقي خطوط التلفريك وسكة القطار التي كانت تصل حتى مدينة أبوزنيمة.
ورفض أهالي منطقة سرابيط الخادم بجنوب سيناء، إقدام شركة سيناء للمنجنيز، على تفكيك تلفريك نقل المنجنيز، الموجود في المدينة الصناعية التي أنشأها الإنجليز فوق قمة جبل «أم بجمة» في بداية القرن العشرين، والتي توصف بأنها تراثا صناعيا منذ اكثر من 150 عاما ومدينة تاريخية فريدة تجذب سياح السفاري من مختلف الجنسيات. فمنع أهالي المنطقة عام 2024 المقاولين من تفكيك التلفريك وبيعه «خردة»، باعتباره أثرا تاريخيا، وتقدموا بشكاوى لكثير من الجهات لمنع التفكيك، مطالبين بالحفاظ عليه وإصلاح باقي خطوط التلفريك وصيانتها وإعادة تشغيلها والاستفادة منها في جذب السياح، وحيث يعد هذا التلفريك أول تلفريك في مصر والعالم العربي. يضاف الي ذلك وعي اهل المنطقة، وبخاصة وان حياة البدو في تلك المنطقة تعتمد على البيئة والسياحة ولابد من الحفاظ على ذلك التراث الإنساني الذي يؤرخ استخراج المنجنيز والفيروز من المنطقة التي تضم معبدالإلهة حتحور الشهير بمعبد «سيدة الفيروز».
ومن الناحية الأثرية يؤكد المختصين بالآثار، إن منطقة أم بجمة التي تقع بالقرب منطقة سرابيط الخادم الأثرية يمكن اعتبارها منطقة تراث صناعي فريدة، حيث تضم مدرسة ومنازل ومستشفى ومسرح وسكة حديد بالإضافة للطقس الرائع الذي تمتع مرتفعات المنطقة. يضاف الي ذلك ان بدو سرابيط الخادم وأم بجمة يطالبون بالحفاظ على خطوط التلفريك الموجودة في قمة جبل أم بجمةـ لأنها تراث صناعي فريدة يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى علاوة على إنها منطقة جذب سياحي لعشاق السفاري.
مثال 4: تسجيل الحفريات والنقوش وبخاصة بصحراء البحر الأحمر
نقوش إنسان ما قبل التاريخ بصحراء البحر الأحمر تبحث عن تسجيلها أثريًا، وحيث تزخر صحراء بالبحر الأحمر بالمناطق الأثرية والتاريخية التي تحمل آثار مختلف العصور والحضارات وتمتد هذة الآثار من الزعفرانة شمالا وحتي الحدود المصرية السودانية جنوبا وتمثل النقوش الصخرية المنتشرة بعدة مناطق في صحراء البحر الأحمر شهادة على الحياة التي عاشها الإنسان القديم في بيئة صحراوية قاسية بالصحراء الشرقية.
وتلقي صحراء البحر الأحمر بالضوء على تطور القدرات الفنية وتفاعلهها مع محيطها، ومع الاستمرار في البحث والتوثيق لهذه المخربشات والآثار بالصحراء الشرقية، يمكن للمنطقة أن تصبح واحدًا من أبرز المواقع الأثرية التي تكشف عن تاريخ الإنسان في العصور القديمة.
فداخل صحراء واودية مصر الشرقية توجد العديد من الآثار التي تمثل عصورًا تاريخية مختلفة، بدءًا من العصور الفرعونية والرومانية، وصولًا إلى النقوش والمخربشات التي تعود إلى إنسان ما قبل التاريخ. وتعد صحراء البحر الاحمر محطة أساسية للباحثين والمهتمين في مجال الآثار والتاريخ لاستكشاف تاريخ الإنسان القديم وتوثيقه تعكس تاريخ الإنسان في هذه المنطقة الصحراوية الجافة.
وتضم كذلك مئات النقوش الحجرية التي تمثل صورًا لحيوانات وطيور تعود إلى العصور ما قبل التاريخ، ما يدل على تواجد الإنسان القديم في هذه المنطقة، وعلى تفاعلهم مع بيئتهم المحيطة إلا أن هذه المنطقة لا تحظى بالاهتمام الكافي من وزارة السياحة الآثار، رغم ما تحتويه من كنوز تاريخية. فحتى الآن، لم يتم اكتشاف وتوثيق هذه الآثار بالشكل المناسب، ما يجعلها في حاجة ماسة إلى التنقيب والبحث العلمي لتسجيلها رسميًا كموقع أثري.
ويؤكد المختصين أن العديد من المناطق الأثرية في جنوب البحر الأحمر تستحق المزيد من الاهتمام، موضحًا أن النقوش الصخرية هي واحدة من أبرز هذه المناطق. تقع هذه المخربشات. كما تظهر نقوش فرعونية ورومانية في العديد من الأماكن. ويعد وادي أبرق ووادي ابوسعفة من المناطق الغنية بالآثار التي لم تُوثق بعد، وهو يحتاج إلى اهتمام أكبر من قبل وزارة السياحة والآثار لضمان تسجيل هذه المواقع رسمياً كمناطق أثرية محمية.
خاصة وإن هذا النوع من النقوش والرسومات يمثل جزءًا كبيرًا من تاريخ الإنسان في هذه المنطقة، ويجب العمل على حفظه ودراسته بشكل جاد حيث يأمل العديد من المهتمين في مجال الآثار أن يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على النقوش التي تحتوي عليها، حيث من شأن ذلك أن يسهم في توسيع فهمنا للتاريخ البشري في العصور القديمة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة الثقافية في جنوب البحر الأحمر وهو يحتاج إلى اهتمام أكبر من قبل وزارة السياحة و الآثار لضمان تسجيل هذه المواقع رسمياً كمناطق أثرية محمية.، حيث من شأن ذلك أن يسهم في توسيع فهمنا للتاريخ البشري في العصور القديمة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة الثقافية في جنوب البحر الأحمر.
فيما أكد مسؤولو آثار البحر الأحمر أن النقوش والرسومات الصخربة التي تزخر بها الصخور في جنوب البحر الأحمر هي عبارة عن رسومات تمثل الحيوانات، ومنها الأبقار والجاموس والفيلة، إضافة إلى حيوانات مفترسة.
وتعكس هذه الرسومات الحياة اليومية للإنسان القديم، حيث كانت تمثل الحيوانات التي كان يشاهدها الإنسان في بيئته الطبيعية وتعد هذه الرسوم الصخرية من أبرز الأشكال الفنية التي خلفها الإنسان ما قبل التاريخ، ورغم أنها قد تبدو بسيطة، إلا أنها توفر معلومات ثمينة عن الأسلوب البدائي في التعبير الفني.
وتنتشر هذه الرسومات بكثافة على الصخور ، حيث تكشف عن اهتمام الإنسان القديم بمراقبة وتوثيق الحيوانات التي كان يتعامل معها في حياته اليومية.
وأوضح مسؤولو آثار البحر الأحمر أن هذه الرسوم الصخرية لا تتميز بالدقة المتناهية التي عُرفت عن الفراعنة، لكنها تمثل نمطًا تقليديًا يعكس طبيعة الصخور التي كانت صعبة النقش عليها بشكل متقن. وفي المقابل، كان الفراعنة يتميزون بنقوشهم الدقيقة والمتقنة.
ويعتقد الباحثون أن هذه النقوش الصخرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كان الإنسان القديم يستخدم هذه الرسومات لتوثيق المشاهد الطبيعية، بما في ذلك الحيوانات المفترسة التي كانت تُشكل تهديدًا له، ما يعكس سعيه المستمر للعثور على مكان صالح للعيش بالقرب من مصدر للمياه
مثال 5: تسجيل «مونس كلوديانوس».. كنز روماني مهمل في صحراء سفاجا
على بعد 45 كيلومترًا من مدينة سفاجا، وسط صحراء قاسية الجغرافيا وغنية بالتاريخ، تقع مدينة ومحجر «مونس كلوديانوس» الأثرية، أحد أهم وأكبر المواقع الرومانية في الشرق الأوسط، التي تنتظر قرارًا حاسمًا من رئاسة الوزراء ليعلن حمايتها رسميًا، ويحمي ما تبقى من معالمها الفريدة والتاريخية.
وكانت مدينة الرخام الإمبراطوري «مونس كلوديانوس » مركزًا حيويًا للإمبراطورية الرومانية، حيث يعمل آلاف العمال تحت إشراف الجيش الروماني في تقطيع الرخام والأحجار الضخمة، التي شُحنت من سفاجا إلى روما لبناء أفخم معابدها وقصورها، مثل فيلا الإمبراطور «هادريان » و«معبد فينوس» بعض الأعمدة التي خرجت من هذه المحاجر لا تزال قائمة في قلب العاصمة الإيطالية حتى اليوم، تحمل توقيعًا غير مكتوب لصحراء مصر.
وتفتقر المدينة والمحجر الروماني لأي سياج أو حراسة، وتتعرض معالمها لتعديات متكررة، وسط تجاهل رسمي استمر لعقود، وفي عام 2017، زارها وزير الآثار الأسبق الدكتور خالد العناني، وأوصى بخطة عاجلة لتأمينها وتطويرها، لكن كل التوصيات بقت حبيسة الأدراج، في انتظار توقيع طال انتظاره من رئيس الوزراء منذ أكثر من 6 سنوات، لضم المدينة ضمن قائمة المناطق الأثرية المحمية.
وتضم المدينة بقايا معمارية نادرة: أعمدة رخامية ضخمة يتجاوز طول الواحدة منها 20 مترًا، ووزنها 200 طن، بقايا مساكن العمال، أبراج مراقبة، إسطبلات للثيران، كنائس من الجرانيت الوردي، وآبار مياه معدنية، ونصوص رومانية منقوشة، لا تزال تتحدى عوامل الزمن.
ومدينة «مونس كلوديانوس» تُعد أضخم مدينة رومانية للعمال في الشرق، وأنها تُمثل فرصة نادرة لإعادة إحياء مسار الرخام الإمبراطوري من مصر إلى أوروبا.
مثال 6: كهف الجارة في صحراء الوادي الجديد
في قلب صحراء الوادي الجديد، وعلى بُعد مئات الكيلومترات من أقرب مظاهر الحياة الحضرية، يختبئ أحد أعجب كنوز الطبيعة في مصر: “كهف الجارة“ حيث يُعد الكهف تحفة جيولوجية نادرة لم تُكتشف إلا مطلع القرن العشرين، وهو من أندر الكهوف الكلسية في العالم لما يحتويه من تشكيلات مذهلة من الصواعد والهوابط المتجمدة في الزمن، وكأنها منحوتات فنية من صنع الخيال.
يتميز الكهف بطبيعة نادرة ونقية حيث يمتد الكهف لمسافة تقارب الـ60 مترًا داخل باطن الجبل، في بيئة نقية لم تلمسها يد الإنسان إلا نادرًا، مما جعله وجهة مفضلة للجيولوجيين والمستكشفين، ومصدرًا للأساطير المحلية عن الأرواح والطاقة الغامضة. وبذلك يعد أحد عجائب الصحراء الغربيةويطلق عليه أسماء متعددة لكن المنتشر عنه أنه أحد عجائب الصحراء الغربية المصرية، موجود في واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى بعد حوالي 7 كيلومترات شرقًا من محمية الصحراء البيضاء.
كما يعد كهف “الجارة” كما وصفه العلماء بأنه “من أجمل ما تراه عيناك في طبيعة الصحراء”، ويقع بالقرب من كثبان أبو محرق الرملية بالقرب من درب قديم للقوافل يربط واحة الفرافرة في الصحراء الغربية بأسيوط فى صعيد مصر.
يعتبر الكهف وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يأخذ زائريه في رحلة عبر الزمن لاستكشاف تاريخ المنطقة العريق واكتشاف روائع الطبيعة الخلابة ويرجع لعصر .
ويعود تاريخ اكتشاف كهف الجارة إلى عام 1873 على يد المكتشف الألماني جيرهارد رولفز. والدراسات الأثرية تشير إلى أن الكهف كان مأهولًا بالسكان في العصر الهولوسيني الرطب، حيث عُثر على رسوم جدارية تصور أنشطة الصيد واللعب التي مارسها الإنسان في تلك الحقبة.
يتكون الكهف من مجموعة من المغارات التي تقع على عمق أكثر من 50 مترًا تحت سطح الأرض. ويتميز بتكوينات صخرية فريدة من نوعها، تُعرف جيولوجيًا باسم رسوبيات الصواعد والهوابط، والتي تشكلت نتيجة لتسرب المياه الجوفية على مدار ملايين السنين تصل الى 40 مليون سنة .ووجد العلماء والباحثون رسوما جدارية، تُعدّ تلك الرسوم الموجودة على جدران كهف الجارة من أهم كنوزه الأثرية، حيث تُصوّر هذه الرسوم مشاهد من حياة الإنسان في العصر الهولوسيني، مثل: الصيد والرعي والطقوس الدينية،تُعدّ هذه الرسوم مصدرًا هامًا للمعلومات حول تاريخ المنطقة وثقافتها.
وجرى أول مسح أثرى على أسس علمية للرسوم الموجودة بالكهف في العام 1990 على يد مجموعة رائعة من المتخصصين فى هذا المجال من كولونيا وبرلين والقاهرة، وفي بداية عام 1999 وحتى العام 2002 تمت دراسة الرسوم والزخارف بصورة مكثفة ضمن مشروع علمي متكامل.
والكهف ذو أبعاد سحرية نشأ كنتيجة طبيعية للماء، حيث النقي ومناخ الصحراء الجاف خلال ملايين من السنين، وهو يخالف كل كهوف المنطقة فى تكويناته وشكل رسوبياته الرائعة، وتصل ارتفاعات التكوينات الرسوبية حسب وصف رولفز إلى ثلاثة أو أربعة أقدام.
وتُعد الأشكال الرسوبية الهابطة والصاعدة بالكهف أشبه ما تكون بشلالات مياه متجمدة، وهي نتيجة لملايين من الأمتار المكعبة من المياه الأرضية التي تسربت خلال رمال الصحراء منذ ملايين من السنين وخلقت هذا الكهف الأرضي ثم جرى ترسيبها وتكثيفها بفعل الحرارة الشديدة. وبالكهف رسوم تمثل الأنشطة المعتادة لإنسان تلك المنطقة مثل الصيد واللعب، وترجع الرسوم إلى عصر الهولوسين الرطب؛ ففى ذلك الوقت سكن تلك المنطقة صيادون ومارسوا أيضا مرحلة جمع والتقاط الثمار، وتوحي الرسوم إن منطقة الجارة بما هي عليه الآن من جدب وعدم استعداد للحياة قد كانت يوما مأهولة بالسكان ومفعمة بالحياة. وبذلك فكهف الجارة ليس مجرد تجويف صخري في عمق الصحراء، بل هو سجل طبيعي حيّ يحكي قصة الأرض عبر ملايين السنين.
ويظل هذا الكهف شاهدًا على روعة الخلق وعظمة الطبيعة، ومقصدًا يستحق أن يُدرج على خارطة السياحة البيئية والجيولوجية في مصر ويتم تسجيله في اليونسكو
ثانيا: التراث غير المادي للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأجداد وتحسين الحياة العصرية
مثال 1: فانوس رمضان: ميراث تاريخي وتراث شعبي
عرف المصريون الفانوس ومنهم انتقل إلى باقى دول العالم.. كان الفانوس قديما يستخدم فى الإنارة وكان يسمى بالمصباح وظهر ذلك جليا فى العصر الفاطمى.
وانتشر فانوس علاء الدين فى ذلك الوقت. وكان يوضع فيه فتيل يضاء بمادة زيتية، وقد تعددت الروايات المختلفة حول ظهور فانوس رمضان قبل أكثر من ألف عام مرتبطا بالخلافة الفاطمية، إذ تشير الرواية الأولى إلى خروج المصريين فى جموع كبيرة ومواكب ضخمة لملاقاة الخليفة المعز لدين الله الفاطمى على أطراف الصحراء، حاملين المشاعل والفوانيس المضاءة والمزينة مهللين لمجيئه وقدومه لمصر، وتصادف أن كان ذلك فى بدايات شهر رمضان، وهكذا بقيت الفوانيس لإضاءة الشوارع حتى انقضى شهر رمضان كله، فأصبحت عادة تتكرر فى هذا الشهركل عام. أما الرواية الثانية فتشير إلى أن الخليفة المعز لدين الله الفاطمى أمر شيوخ المساجد بإنارتها بالفوانيس فى رمضان، حتى يسهل وصول المصلين لإقامة صلاة التراويح.
وهناك كذلك رواية ثالثة فى العصر الفاطمى أيضا وتحديدا فى عهد الحاكم بأمر الله، أقل ترجيحا، إذ كان ممنوعا على نساء القاهرة الخروج ليلا، فتم استثناء هذا المنع فى شهر رمضان لحاجتهن لارتياد المساجد وأداء التراويح، وبشرط أن يتقدم المرأة أو الفتاة صبى يحمل فانوسا، لينتبه المارة إلى أن هناك امرأة قادمة فى الشارع، فيفسح الرجال لها الطريق، فكان ذلك بداية لاعتياد الصبية والأطفال على حمل الفوانيس فى الشوارع فى رمضان.
وقد حظى الفانوس بنصيب وافر من اهتمام الأدباء والشعراء، حيث دبجت العديد من الأشعار التى تدور حول فكرته ووظائفه أوتستلهمه كمفردة تراثية بُنى عليها العديد من الأعمال الفنية، كما فرض الفانوس حضوره على العديد من الأغنيات الرمضانية، التى التفَّت حوله واستلهمته فى الكتابة. كذا كان الفانوس مادة اجتماعية وفيرة، راح ينهل منها العديد من الكتاب أفكارهم القصصية.
وقد ظل شعب مصر مجيد التمتع بشهررمضان وإحياء لياليه، وإضافة عادات وطقوس تخلق أجواء من البهجة والاحتفالية بالشهر الكريم، وحافظ عليه حتى الآن، ومنها الفانوس الذى أبدع المصريون فى صناعته التى بدأت من الصفيح ثم النحاس ثم أصبح يضاف إليه الزجاج الملون ليصبح مبهجا متعدد الأشكال والألوان.
وازدهرت صناعة الفوانيس بشكل كبير فى عصر دولة المماليك، حيث ظهر سوق «الشماعية» أوالشماعين فى حى النحاسين خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين، أصبحت القاهرة مركزًا مهمًا لصناعة الفوانيس، حيث تخصصت أحياء مثل حى الأزهر والغورية وبركة الفيل فى هذه الحرفة، ورغم أن الفوانيس التقليدية المصنوعة يدويًا من النحاس والخشب والمزينة بالزجاج الملون تحظى بشعبية كبيرة، لما تضفيه من لمسة تراثية على أجواء رمضان، إلا أن ذلك لم يمنع وجود أنواع أخرى من الفوانيس البلاستيكية التى تتميز بانخفاض تكلفتها وتنوع تصاميمها وألوانها، والإلكترونية التى تتميز بإمكانية تشغيلها بواسطة البطاريات أوالكهرباء، وبعضها يأتى مع مؤثرات صوتية وضوئية تضيف إلى البهجة الرمضانية، وكذلك ظهرت فوانيس رقمية يمكن برمجتها لتعرض رسومات متحركة أوكتابات مضيئة، مما يجعلها مناسبة للديكورات الحديثة.
وفانوس رمضان له وظيفة احتفالية، فهو مظهر ثقافى احتفالى مهم، حتى أصبح ظاهرة ثقافية مصرية رمضانية، تحولت عبر الزمن من مجرد كونها وسيلة للإضاءة ليلا، إلى وظيفة كرنفالية احتفالية؛ ولتصبح أيضا صناعة ثقافية وحرفة تراثية، ومصدر دخل مهما للعديد من الأسر المصرية، تتركز مناطق صناعته بين صناع مبدعين ومهرة فى مناطق أشهرها منطقة «الربع» المتفرع من ميدان باب الخلق بالقاهرة.
وصناعة الفوانيس حرفة تراثية ذات جذور ممتدة فى دروب التاريخ المصرى، وأغلب صناع الفوانيس يعملون بمهنة السمكرى البلدى طوال العام، وهى مهنة مختصة بعمل المشغولات من الصفيح، وأعمال اللحامات وكذلك إصلاح «الوابورات»، وصانع الفوانيس، فى ماضى هذه الحرفة، كان يحرص على نقش اسمه على قاعدة الفانوس.
وحيث تتعدد احجام وأشكال ومسميات الفوانيس والتى تُستلهم غالبا من مفردات البيئة المحيطة، فى حالة من الأخذ والعطاء التى يتسم بها الفولكلور عامة.
فهناك: الفانوس «المقرنص»، المستلهم شكلا واسما من المقرنصات وهى واحدة من علامات العمارة الإسلامية، وقبة البرلمان المصنوع على هيئة قبة مبنى البرلمان المصرى، و«الفنار»، نسبة إلى فنار الإسكندرية، و«العدل»، الذى تتساوى قاعدته مع أضلاعه، و«شقة البطيخ» المصمم على هيئة شقة البطيخ، و«الشمامة»، إضافة إلى الفانوس «أبو أولاد»، وهو عبارة عن فانوس كبير تحيط بجوانبه الأربعة فوانيس أصغر كأنها أولاده.. إلخ.
وأهم التحديات التى تواجه هذه الصناعة هو ارتفاع سعر الصرف الذى ترتبت عليه زيادة أسعار بعض المواد الخام الداخلة فى تصنيع وتذهيب الفانوس.
هذا وقد تم فى الارشيف القومى للمأثورات الشعبية التعرض للجمع الميدانى للفانوس بشكل عابر حيث لم يصل دوره فى الدراسة المتعمقة، وجاءت دراسته فى اطار ظواهر رمضان فى مصر، وقد سبق وأجريت دراسة عن الفانوس فى عام 1998 ببركة الفيل أظهرت كيف يقوم الفنان بلحام أجزاء الصفيح بالقصدير ويكون هيكل الفانوس ثم يضع الزجاج الملون وذلك فى مراحل انتاج الفانوس وهى اولاً قص وتشكيل الصفيح، ثم مرحلة تقطيع الزجاج حسب النوع والمقاس، ثم عملية اللحام، ثم مرحلة التلوين، ثم تركيب اليد التى يعلق منها الفانوس، وكل مرحلة من هذه المراحل يختص بها عامل فى فترة الموسم، وبعدها يقوم عامل بكل المراحل، ويوضح نوار أن بعض الصانعين يحافظون على استخدام الخامات القديمة (كالصفيح والزجاج) كجزء من الحفاظ على التراث وخاصة فى الفوانيس الكبيرة التى تستخدم الآن لتزيين مداخل العمارات والمولات.
هذا وتُعد صناعة الفانوس مثالًا على إعادة التدوير، حيث استُخدمت المواد المتاحة بذكاء لانتاج رمز رمضانى أصيل فى بداياته، كان الفانوس يصنع من المعدن مثل النحاس أوالبرونز، ويُزين بنقوش وزخارف إسلامية. ومع مرور الزمن، تطورت صناعة الفوانيس وأصبحت تُصنع من مواد مختلفة مثل الزجاج الملون والمعادن الخفيفة، كما تم إدخال الإضاءة الكهربائية لتحل محل الشموع مما جعل الفوانيس أكثر أمانًا وسهولة فى الاستخدام.
والفانوس التقليدى يفرض حضوره – مهما تقادم به الزمن – فى الحياة المصرية بقوة، وبدأت تظهر أشكال جديدة من الفوانيس المصنوعة من خامات جديدة غير الصفيح التقليدى، منها الفانوس المصنوع من الخرز، والفوانيس المصنوعة من رقائق الخشب، بتقنية القص بالليزر، إضافة إلى الفوانيس المصنوعة من جريد النخيل وأعواد الخشب وشرائح البلاستيك المقوى. كما استلهم شكله فى صناعة العديد من المجسمات المرتبطة بشهر رمضان والمعبرة عنه. وهى أمور تدلل جميعها على أن الفانوس ما زال يقوم بدوره التقليدى الذى رافق المصريين عبر دورات التاريخ المختلفة وأنه ما زال قادرا على إشباع الوجدان وتغذيته، ولذلك استطاع أن يفرض استمراره ويجدد حضوره وارتباطه بعناصر ثقافة البيئة المحيطة. ويتم تصدير الفوانيس الي الدول العربية، كما يقبل على شرائها علية القوم من أصحاب الفيلات والفنادق الفخمة، حيث يعد مظهرا من مظاهر الديكورات الحديثة، حيث يجمع بين جمال التصميم وخصوصية زخارفه الثقافية، وبين قوة إضاءته، وحيث أصبح يستخدم فى الديكورات الحديثة بشكل كبير أى أنه محافظ على وجوده بقوة.
وانتقل الفانوس المصرى إلى دول عديدة وأغلب الدول العربية، وعواصمها ليصبح جزءا من تقاليد المظاهر الاحتفائية بشهر رمضان لديهم أيضا، وبالطبع كل مكان يضفى لمسات من بيئته وثقافته على شكل ووظيفة الفانوس وخاماته.
ورغم أهمية «الفانوس» وارتباطه بالثقافة الشعبية والمأثورات المصرية إلا أنه لم يتم تسجيله حتى الآن ضمن قائمة عناصر التراث غير المادى باليونسكو، بالرغم من أن «الفانوس» مسجل بالفعل على الأرشيف القومى للمأثورات الشعبية، وفى أطلس الفنون الشعبية والمأثورات الشعبية، ومسجل أيضا على القوائم الوطنية، أما مسألة التسجيل على قائمة التراث باليونسكو فلها اجراءات معينة، ونظام لا يسمح للدولة الواحدة إلا بتسجيل عنصر منفرد كل عامين. وهو ما يجعله قابل للتسجيل كتراث ثقافي، ومن ثم ضرورة التفكير فى إعداد ملف لتقديمه إلى اليونسكو؛ لإدراج عنصر الفانوس ضمن القائمة التمثيلية باليونسكو، وذلك بوصفه عنصرا ثقافيا، وملمحا مصريا بارزا، ضاربا فى جذور التاريخ المصرى، ولا يزال يؤدى وظيفة ثقافية واقتصادية مهمة بين المصريين، وهو ما يتطلب وضع قاعدة بيانات دقيقة عن مختلف العناصر المرتبطة بالفانوس، من أجل إعداد ملف علمى دقيق يبين قيمة الفانوس وتاريخه الممتد وأهمية تسجيله. إضافة إلى ضرورة تدخل المؤسسات الثقافية وتبنيها الفكرة ودعوة المختصين من أجل وضع خطة تليق بقيمة العنصر وتشجع على الموافقة عليه كتراث وصناعة تجمع بين الإبداع والاحتراف، مع الاستفادة من الخبرات التى تشكلت لدينا سواء مما تم تسجيله مسبقا على قائمة التراث العالمى أومما وُضع على القائمة.
مثال 2: كعك العيد صناعة عمرها 5000 سنة
يُعد كعك العيد أحد أقدم وأشهر التقاليد التى ارتبطت بالاحتفال بعيد الفطر فى مصر والعالم العربى.. وكعك العيد في مصر له تاريخ، حيث تعود جذور هذا التقليد إلى آلاف السنين، حيث بدأ فى العصر الفرعونى واستمر تطوره عبر العصور الإسلامية حتى أصبح رمزا للفرح والاحتفال..
ويعود تاريخ كعك العيد إلى أكثر من 5 آلاف عام، حيث كان المصريون القدماء يصنعونه كجزء من القرابين المقدمة للآلهة فى المعابد، وقد كشفت النقوش الموجودة على جدران المقابر الفرعونية عن مشاهد لصناعته، مثل مقبرة الوزير «خميرع» من الأسرة الثامنة عشرة، حيث تظهر النساء وهن يعجنّ الدقيق، ويضفن العسل، ويشكّلن العجين على هيئة دوائر قبل عملية الخبيز، كما أن النقوش المرسومة على الكعك كانت تمثل قرص الشمس، التى كانت رمزا مقدسا لدى المصريين القدماء، فشكل الأقراص الدائرية المزيّنة بنقوش زهرة اللوتس أو الشمس، هي رمزية واضحة لتجدد الحياة.. وبهذا ثابت نسبة طقس وعادة صناعة الكعك وتقديم الحلوى في الأعياد إلى المصريين القدماء، وأدلتها الكثيرة بمقابر «طيبة» و«سقارة» المليئة بنقوش تصوّر تقديم الكعك والمعجنات خلال الأعياد.
وعرف المصريون القدماء أكثر من 300 نوع من المخبوزات سجلت على جدران المعابد والمقابر منذ عصر الدولة القديمة، وارتبطت بالمناسبات والاحتفالات المصرية التي تسمى “حب” وتعني عيد أو احتفال، وأهم هذه المخبوزات هى“k3k” والتي تعني العجين في اللغة المصرية القديمة، كما عرفت في القبطية باسم “kaak”، ثم انتقلت إلى اللغة العربية “كعك” بنفس النطق والمعنى، ومنها إلى اللغات الأوروبية وعلى رأسها الإنجليزية” cake”.
وانتقل التقليد إلى العصر الإسلامى، فمع دخول الإسلام إلى مصر، استمرت صناعة الكعك كجزء من تقاليد الاحتفال بعيد الفطر، ولم يكن الأمر مقتصرا على العائلات فقط، بل أصبح من العادات التى تتوارثها الأجيال وتنتقل إلى الدول الإسلامية الأخرى، مثل بلاد الشام والعراق، حيث عُرف هناك بـ «المعمول».
الدولة الإخشيدية سبقت الفاطميين في العناية بالكعك، وتشتهر قصة الوزير الإخشيدي أبي بكر محمد بن علي المادرائي، الذي صنع كعكًا محشوًا بالدنانير الذهبية، وكان يُعرف آنذاك باسم “افطن له”، وهو دليل على الأهمية الكبيرة التي أولتها الدولة الإخشيدية للكعك قبل الفاطميين. إلا أن العصر الفاطمى (909 ـ 1171م) شهد ازدهارا غير مسبوق فى صناعة الكعك، حيث خصص الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ديوانا خاصا يُعرف باسم «دار الفطرة»، كان يعمل فيه أمهر الطهاة لإعداد كميات ضخمة من الكعك لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين خلال عيد الفطر، وكان يُنقش على الكعك عبارات مثل «كل واشكر»، وهى عادة مازالت موجودة حتى اليوم.. كما تم استخدام قوالب خشبية لنقش أشكال وزخارف مختلفة على الكعك، وهو تقليد مستوحى من العصور الفرعونية.
تطورت صناعة الكعك فى العصرين المملوكى والعثمانى، واستمرت كجزء من الاحتفالات، لكنها أصبحت أكثر تنوعا وفخامة، حيث أُضيفت إليه المكسرات، وأصبح يُزين بالسكر الناعم. ولم يقتصر الإبداع المصري على صناعة الكعك فقط، بل شمل أيضًا القوالب المنقوشة والمكتوبة التي كانت تُستخدم في تحضيره، ولا يزال بعضها محفوظًا في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. وهكذا ظل كعك العيد جزءا من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، ولاتزال العائلات المصرية والعربية تحرص على تجهيزه فى الأيام الأخيرة من رمضان، ولايزال يحتفظ برمزيته كعنصر أساسى بفرحة العيد. ويعد من الأكلات المصرية الواجبة التسجيل لحفظ هويتها المميزة
مثال 3: التقويم القبطي صاغ هوية المصريين
تشكل الشهور القبطية وما أرتبط بها من عادات اجتماعية وزراعية يمارسها المصريون جميعاً نوعاً من الارتباط بالتراث المصري القبطي، كما أنها تدل على عراقة وأصالة في الهوية والثقافة المصرية، والتي ظهرت من خلال تسجيل الأمثال وحفظها ودلالتها سواء كانت زراعية أو مناخية أو اجتماعية، وتعطي صورة عن صور الحياة الاجتماعية المصرية.
وكلمة قبط تعني مصر باللغة المصرية القديمة. ودور التقويم القبطي ليس فقط بالزراعة والمناخ والاعياد الدينية والحساب وأنما أيضا في العقل الجمعي للمصريين حتى الآن. ومن ذلك الأمثال والحكم المصرية المرتبطة بالتقويم المصري القديم مرتبط بالأمثال المصرية ومنها: بابه ادخل واقفل البوابة -طوبة تخلي الصبية كركوبة- برمهات روح الغيط وهات.
والتقويم المصري القبطي، هو أحد أهم عناصر التراث القبطي التي مازالت محفوظة إلى يومنا هذا في التراث الشعبي المصري، والتقويم القبطي وما أرتبط به من عادات وتقاليد ورثها المصري المسيحي والمسلم، محفوظة في السنة الزراعية والأمثال الشعبية والاحتفالات الدينية التي إرتبطت بكل شهر من شهور السنة القبطية وظلت راسخة في الوجدان، هذه العادات يشترك فيها المسيحي والمسلم على اختلاف ثقافتهم، والتقويم القبطي هو في الأصل التقويم المصري القديم. وتوافق بداية السنة القبطية (الأول من شهر توت) يوم 11 سبتمبر في السنة الميلادية.
أما التقويم القبطي فيبدأ اعتبارا من عام 284 ميلادية. فبالبرغم دخول المسيحية إلي مصر علي يد مرقس الرسول في منتصف القرن الأول الميلادي فإن الأقباط احتفظوا بالتقويم المصري القديم كغيره من التقاليد والعادات المصرية دون تغيير، إلي أن اعتمدوا العمل بالتقويم القبطي في القرن الرابع الميلادي، ويبدأ هذا التقويم بتولي الامبراطور الروماني دقلديانوس الذي اشتهر عصره في التاريخ القبطي بعصر الشهداء نظرا للاضطهاد والمذابح التي عانها الأقباط علي أيدي هذا الامبراطور.
والتقويم القبطي، تقويم شمسي مرتبط بالزراعة والمواسم المختلفة لها، والسنة القبطية 13 شهر، عبارة عن ثلاثة مواسم كل موسم 4 شهور كل شهر 30 يوماً، والشهر الأخير عبارة عن 5 أيام في السنة البسيطة و6 أيام في السنة الكبيسة، وقد أرتبطت بهذه الشهور مجموعة من العادات والتقاليد المرتبطة بالزراعة وأحوال المناخ، هذه الأمثال أطلقها المصري وتوارثها الأجداد ثم الأحفاد، وظلت محفوظة في الذاكرة الوطنية والثقافة المصرية كأحد عناصر الهوية التي تميز النظام الزراعي في مصر، ولا نبالغ إذا قلنا أن التقويم القبطي عبارة عن دفتر أحوال للسنة الزراعية المصرية، تشترك فيها علم الزراعة مع الفلك والمناخ، وهو ما وضحه الرحالة والمؤرخين .
العلاقة بين التقويم والهوية المصرية يبرز في اوضح صوره
فيما ارتبط بالشهور القبطية من تلك الأمثال الشعبية التي صاغها المصري، لكي تعبر عن أحواله خلال مواسم السنة، ورأس السنة القبطية ” شهر توت” الذي يبدأ في 11 سبتمبر وينتهي في 10 أكتوبر، وارتبط بهذا الشهر أمثال منها ” توت يقول للحر موت” الذي يدل انتهاء فصل الصيف وإنكسار الحر ” توت أروي ولا تفوت” أي يجب ري الأرض في توت وغيرها من الأمثال، مثل ” توت حاوي توت” و” في توت لا تدع الفرصة تفوت”.
و” شهر بابة” يبدأ في 11 أكتوبر وينتهي في 9 نوفمبر، وارتبط به عدة أمثال ” بابة خش وأقفل الدرابة” أي طاقة البيت أو الشباك بسبب البرد، و” إن صح زرع بابة يغلب النهابة وإن خاب زرع بابة ما يجبش ولا لبابة”، ثم يأتي الشهر الثالث ” هاتور” يبدأ في 10 نوفمبر وينتهي 9 ديسمبر والأمثال المرتبطة به ” هاتور أبو الدهب منثور” كناية عن زراعة القمح، و” إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور”.
أما “شهر كيهك” يبدأ في 10 ديسمبر وينتهي في 8 يناير ويرتبط به عدة أمثلة تدل على العادات الاجتماعية والزراعية والوقت مثل ” كياك صباحك مساك تقوم من فطورك تحضر عشاك” وهى دلالة على قصر النهار في كيهك، ” كياك تقوم من النوم تحضر عشاك” و“كياك صباحك مساك شيل إيدك من غداك وحطها في عشاك” ومثل آخر هو” البهايم اللي متشبعش في كياك إدعي عليها بالهلاك”.
ثم يأتي “شهر طوبة” والذي يبدأ في 9 يناير حتى 7 فبراير، وفيه يتم تطويب الأرض وتنمو فيه المحاصيل الزراعية، وارتبط به أمثال ” طوبة يخلي الشابة كركوبة” و” طوبة يخلي الصبية جلدة والعجوزة قردة” و” طوبة فيه البرد والأعجوبة “ دليل على شدة البرد، ويرتبط بشهر طوبة عيد الغطاس والمثل الشعبي المرتبط به ” اللي مياكلش قلقاس يصبح جتة من غير راس”، بعد طوبة يأتي “شهر أمشير” ويبدأ في8 فبراير وحتى 10 مارس ويرتبط به أمثال زرعية ومناخية مثل ” أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير” و ” أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد الهدوم ويطير” و” أمشير أبو الزعابير الكتير أبو الطبل الكبير” و ” أمشير يقول لبرمهات عشرة مني خد وعشرة منك هات نطير العجوز بين السفكات” وكلها تدل على تقلب الأجواء فيه من رياح وشمس وأمطار وأتربة.
والشهر السابع في السنة القبطية وهو “شهر برمهات” الذي يبدأ في 11 مارس وينتهي في 8 ابريل ويرتبط عدة أمثال أيضاً مناخية وزراعية حيث قرب موسم الحصاد حيث الشمس والحرارة التي تساعد على نضح المحاصيل الزراعية ومن أمثال هذا الشهر ” برمهات روح الغيط وهات” و ” برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات” و ” برمهات فتش في الغيط وهات من كل الخيرات”.
وبعد برمهات يأتي “شهر برمودة” ويبدأ في 9 أبريل وحتى 8 مايو، وفيه يكون حصاد القمح، ومن أمثاله ” برمودة دق العامودة” أي ضرب سنابل القمح، وبعده يأتي “شهر بشنس” الذي يبدأ في 9 مايو وحتى 7 يونيه، وفيه يكون الليل قصير والنهار طويلاً ومن أمثاله ” بشنس يكنس الغيط كنس” دليل على خلو الأرض والحقول من المحاصيل و” في بشنس خلي بالك من الشمس” وذلك لشدة الشمس وحرارتها.
أما الشهر العاشر من الشهور القبطية فهو “شهر بؤونة” ويبدأ في 8 يونيه وحتى 7 يوليه، ويرتبط به عوامل مناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة وشدة الشمس ويبدأ النيل في الزيادة، ومن أمثال هذا الشهر ” بؤونة نقل وتخزين المؤونة” و ” بؤونة تكثر فيه الحرارة الملعونة”.
و ” شهر بؤونة يقلق الحجر” و ” بؤونة تنشف المية من الماعونة”، ثم يأتي “شهر أبيب” ويبدأ في 8 يوليه وحتى 6 أغسطس، ومن أمثاله ” أبيب فيه العنب يطيب” و ” أبيب مية النيل فيه تريب ” أي تكثر وتزيد، و ” أبيب طباخ العنب والزبيب” و ” إن أكلت ملوخية في أبيب هات لبطنك طبيب” و ” أبيب أبو اللهاليب”.
وبعد أبيب يأتي الشهر الثاني عشر وهو “شهر مسرى” ويبدأ في 7 أغسطس حتى 5 سبتمبر وارتبط به أمثال منها “ مسرى تجري فيه كل ترعة عسرة” و ” في مسرى تفيض المياه على الأرض وتسري” و ” عنب مسرى إن فاتك متلقاش ولا كسرة”، وبعد ذلك يكون الشهر الأخير وهو “النسيء” أو ( الشهر الصغير) ويقع بين 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر، ويرتبط به مثل شعبي “ النسيء تزرع أي شيء ولو في غير أوانه”.
وعن أهمية التقويم القبطي وصلته الوثيقة بحياة المصريين، يستشهد القلقشندي في كتابه “صبح الأعشي في صناعة الأنشا” الذي أورد علي لسان أحد الرحالة قوله: “عرفت أكثر المعمورة فلم أر مثل ما بمصر من ماء طوبة ولبن أمشير وخروب برمهات ونبق بشنس وتين بؤونة وعنب مسري ورطب توت ورمان بابة وموز هاتور وسمك كيهك”.
مثال 4: تسجيل صبغة اللون الأزرق المصري والاحبار المستدامة المولدة للطاقة حماية للملكية الفكرية لاختراعات الأجداد
تعد صبغة اللون الازرق اختراع مصري قديم يستلزم تسجيله. فالأزرق المصري، المعروف أيضًا باسم “سيليكات النحاس والكالسيوم”، هو أحد أوائل الأصباغ الاصطناعية التي استخدمها الإنسان، يقال إن أقدم مثال معروف للصبغة الرائعة يعود إلى حوالي 5000 عام، تم العثور عليه في لوحة مقبرة ترجع إلى عهد كاسين، آخر فرعون من الأسرة الأولى. وكشفت الأبحاث في العقد الأخير عما يميز الأزرق المصري عن غيره من الصبغات حيث يستخدم اليوم في حل ألغاز الجريمة والبحث العلمي بسبب خواصه الكيميائية الفريدة.
ومن بين تلك الأسرار توصل العلماء لما يعرف عالميا بالأزرق المصري The Egyptian Blue، وهو ليس مجرد لون صبغة عادية، فإلى جانب أنه لون كان يصعب تصنيعه في ذاك الوقت، فإن للأزرق المصري خواص كيميائية متعددة يمكن أن تساعد في عدة مجالات. ولم يكن اللون الأزرق شائعا في اللوحات والجداريات في عصور ما قبل الفراعنة، ويرجع ذلك إلى ندرة المعادن الزرقاء وكونها غير مستقرة كيميائيا ويصعب تكوين اللون منها، حيث يوجد الأزرق في الطبيعة في حجر اللازوريت أو حجر لازولي الثمين، وهما من الأحجار النادرة التي يصعب تشكيل اللون منها.
أما في لوحات الفراعنة وجداريات معابدهم ومقابرهم فتجد تشكيلة مثيرة للاهتمام من أشكال الأزرق التي أثبتت الأبحاث أنها ليست من حجر لازولي لابيس أو حجر اللازوريت الطبيعي، الأمر الذي أثار فضول الباحثين لمعرفة المزيد عن مصدر اللون الأزرق في العصر الفرعوني.
الأزرق المصري القديم صبغة الأجداد يولد الطاقة ويبني مستقبلًا صديقًا للبيئة، فقد كشفت دراسة حديثة، نُشرت في Journal of Applied Physics، عن الإمكانات الفريدة لصبغة “الأزرق المصري” التي صنعها المصريون القدماء قبل آلاف السنين، إذ تمتلك هذه الصبغة خصائص تجعلها مثالية لتبريد المباني وتوليد الطاقة في وقتنا الحالي. يعود أصل الصبغة إلى حضارة الفراعنة، حيث أُستخدمت في تصوير الآلهة والملوك، وتعتبر أول صبغة صناعية معروفة، حيث استُخرجت من سيليكات النحاس والكالسيوم.
تُظهر الدراسة أن “الأزرق المصري” يتميز بفلورية تفوق التوقعات(تُعرف الفلورية بأنها عملية إنبعاث الضوء من جسم بعد تعرضه لأشعة أخرى)، بمعدل يصل إلى 10 أضعاف ما كان يُعتقد سابقاً. تمتاز هذه الصبغة بقدرتها على عكس أشعة الشمس حيث أن “الأزرق المصري” يمتص الضوء المرئي ويصدر ضوءاً في نطاق الأشعة تحت الحمراء، ما يساعد على خفض درجات الحرارة في المباني من خلال طلاء الأسطح والجدران بها.
وهذا التأثير يساهم بفعالية في مكافحة الإحتباس الحراري، إذ يقلل الحرارة المتراكمة على أسطح المباني ويخفض من اعتماد المباني على أنظمة التبريد المكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الصبغة خصائص تمكنها من توليد الكهرباء عبر النوافذ المطلية بها، مما يسهم في تقليل إستهلاك الطاقة ويُعزز من دورها كحل مستدام للطاقة في المباني الحديثة. ويعتبر هذا الإكتشاف خطوة نحو تبني حلول بيئية مستدامة، حيث ينضم “الأزرق المصري” إلى قائمة الألوان الفعّالة في تبريد المباني، مثل الأبيض والأحمر الفلوري.
ومع تزايد الإهتمام بالتصميمات المستدامة، يمكن أن يُشكل هذا اللون المصري الأصيل جزءًا من الحلول الحديثة للتحديات البيئية الحالية، ويساهم في الحفاظ على الموارد وتقليل التلوث. ومن ثم توظيف التكنولوجيا الحديثة لإعادة إكتشاف مواد وألوان قديمة تحمل إمكانيات كبيرة لتحسين الحياة العصرية.
ورق البردي وتاريخ الحبر عند المصريون القدماء
كما كشفت دراسة علمية جديدة أجراها فريق دولي من العلماء الأوروبيين على قطع أوراق بردي تعود للقرن الثاني قبل الميلاد أسرار مكونات الحبر الذي استخدمه المصريون القدامى في الكتابة بالبرديات. وأظهر التحليل الذي أجراه الباحثون على 12 قطعة بردي عن بعض التفاصيل المدهشة حول كيفية خلط المصريين للحبر الأحمر والأسود، ونشرت نتائج الدراسة في الدورية الرسمية للأكاديمية الأميركية للعلوم (PNAS) في 26 أكتوبر2020.
فمن المعروف أن قدماء المصريين كانوا يستخدمون الأحبار للكتابة منذ 3200 سنة قبل الميلاد على الأقل، لكن العينات التي قام فريق متعدد التخصصات من الباحثين من جامعة كوبنهاجن والمرفق الأوروبي للإشعاع السنكروتروني European Synchrotron Radiation Facility) (ESRF بدراستها تعود إلى الفترة الرومانية في مصر (حوالي 100م إلى 200 م)، وتم جمعها في الأصل من مكتبة معبد تبتونيس (Tebtunis) الشهيرة، وهي المكتبة المؤسسية الوحيدة المعروفة بأنها نجت من تلك الفترة.
وباستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الإشعاع السنكروتروني الناتج عن تسريع الجسيمات، بما في ذلك استخدام الأشعة السينية عالية الطاقة لتحليل العينات المجهرية، كشف الباحثون عن التركيب الجزيئي والبنيوي للأحبار بتفاصيل غير مسبوقة. وتشير نتائج التحليل الذي أجراه الباحثون إلى أن المركبات التي عثروا عليها في الأحبار الحمراء أساسها الحديد، وتعود على الأرجح لصبغة طبيعية مأخوذة من حجر المغرة الذي يحتوي على نسب من الحديد والألومنيوم والهيماتيت المعدني أو أكسيد الحديد الثلاثي. وبحسب بيان لجامعة كوبنهاجن، فقد تفاجأ الباحثون عند تحليل أوراق البردي بالعثور على مركبات الرصاص غير المعروفة سابقا في كل من الأحبار الحمراء والسوداء، واقترحوا أنها كانت تستخدم لخصائص التجفيف الخاصة بهم بدلا من كونها صبغة.
وبهذا ثبت ان تحاليل الأحبار الموجودة على أجزاء البردي كشفت عن تركيبات لم تكن معروفة من قبل للأحبار الحمراء والسوداء، وخاصة المركبات القائمة على الحديد والرصاص. ووجد الباحثون أن مركبات الرصاص الموجودة في الحبر كانت مختلفة عن أصباغ الرصاص التقليدية المستخدمة في التلوين، مما يشير إلى أنه تمت إضافة هذه المركبات لأغراض فنية وللتجفيف.
وان المجففات التي تحتوي على الرصاص تمنع المادة الرابطة من الانتشار أكثر من اللازم عند وضع الحبر أو الطلاء على سطح الورق، وهو ما يفسر تشكيل الرصاص هالة غير مرئية تحيط بجزيئات المغرة في الحبر، وفقا لبيان للمرفق الأوروبي للإشعاع السنكروتروني.
ويعتقد الباحثون أن كهنة المعابد، الذين كتبوا مخطوطات البردي التي تم تحليلها لم يصنعوا الأحبار بأنفسهم، لأن تركيبتها المعقدة تتطلب معرفة متخصصة، وهم يرجحون بناء على كمية المواد الخام اللازمة لتزويد مكتبة المعبد مثل تلك الموجودة في تبتونس، أن يكونوا قد حصلوا عليها أو أشرفوا على إنتاجها في ورش عمل متخصصة، وما يؤيد هذه الفرضية هو أن تحضير الحبر الأحمر داخل ورشة عمل قد تم ذكره في وثيقة يونانية تعود إلى القرن الثالث الميلادي.
ومن المعروف، أنه تم اعتماد تقنية استخدام الرصاص كعامل تجفيف أيضا في القرن الـ15 في أوروبا عندما بدأت اللوحات الزيتية بالظهور، لكن يبدو أن قدامى المصريين اكتشفوا الحيلة قبل ذلك بحوالي 1400 عام على الأقل. ويعتقد الباحثون أن نتائج هذه الدراسة ستكون مفيدة أيضا لأغراض حفظ الوثائق، لأن المعرفة التفصيلية لتكوين المواد يمكن أن تساعد المتاحف والمجموعات في الحفاظ على التراث الثقافي.
كل ذلك يؤكد أن الأحبار والصبغات المصرية القديمة تستلزم مزيد من الاختبارات وأنواع مختلفة من التحليل، فما تم كشفه حتى الآن يقدم مثالا على الأدوات العلمية الحديثة التي يمكنها أن تكشف المزيد من الأسرار من الماضي، والذي له تطبيقات حديثة تستلزم الدراسة والتسجيل لحماية الملكية الفكرية لابداعات وابتكارات الأجداد.