إسحاق بندري يكتب: سفر الموت.. ومراودة الخلود على دروب الفردوس
إسحاق بندري يكتب: سفر الموت.. ومراودة الخلود على دروب الفردوس

بحسب تعريف الموسوعة البريطانية فإن تيار الوعي أو التداعي الحر هو تدفق غير محدود من الانطباعات البصرية والسمعية والجسدية واللاشعورية التي تلمسُ وعي المرء وتُكَوِّنُ جزءًا من إدراكه. وبدأ استخدام المصطلح للمرة الأولى من قبل عالم النفس وليم چيمس في كتابه “مبادئ علم النفس” مُستَلْهِمًا هذا الاصطلاح من الجريان الدائم لمياه النهر بما يشبه انسياب الأفكار وتداعيها داخل الذهن. ومع تطور تقنيات الرواية النفسية في القرن العشرين حاول بعض الكُتَّاب التقاط التدفق الكلي لوعي شخصياتهم, إذ يدمج الكاتب مقتطفات من الأفكار غير المترابطة والتراكيب غير المُنَسَّقة، لغويًا ونحويًا من خلال المونولوج الداخلي للشخصية.
سفر الموت
ومن خلال هذه التقنية المُعَقَّدَة والمُرَكَّبَة جاءت رواية “سفر الموت” للأديب الكبير شطبي ميخائيل في طبعتها الصادرة حديثًا عن مركز إنسان للنشر, لتُقَدِّم لنا عَبْرَ سردية طويلة غير مُقَسَّمَةٍ إلى فصول, كل هذه التداعيات الذهنية والنفسية للسارد خلال ساعات احتضاره الممتدة منذ فجر يوم السادس عشر من إبريل 1993 والذي يوافق يوم الجمعة الحزينة, إلى أن يلقى نحبه. ولكن ساعات الاحتضار التي تُشَكِّلُ الزمان الفعلي للرواية وبقدر ما تُجَسِّدُ الحالة الأليمة للسارد عزيز باخوم زارع, إلا أنها تروي في تشظياتها الزمانية عن ملحمة كونية يمتزج فيها الخاص مع العام, تتقاطع في ثناياها المأساة الفردية مع التحولات الكبرى في الوطن والعالم.

الأسئلة التي لا مفر من مواجهتها عن معنى الحياة والوجود, وذكريات الإخفاقات المتوالية, تنحصرُ بين سؤالين عن فكرتي الحاضر الآني في مقابل الأبدي الآتي, وإن تشابهت صياغتهما في بداية الرواية وختامها ولكن الفارق ضخم بين المعنيين.
فالسؤال الأول المُوَجَّه من سالومي قريبة السارد: “ـ أخيرًا تذكرت أن لكَ بيتًا هنا؟” في إشارة لعودته لقضاء أيامه الأخيرة في سرايا العائلة بعد أن تداعى وتقوض التاريخ العريق لآل زارع, يتناقض بجلاء مع السؤال الأخير من منرفا عمة السارد الراحلة وقد تبدى له صوتها من العالم الآخر إذ أوشكت رحلته على نهايتها ليتخلص من وجعه المبرح: “ـ أخيرًا تذكرت أن لكَ وطنًا؟”
لماذا عاد لأرض الأجداد؟
وما بين السؤالين تتوالى هلاوس السارد لدرجة لا يكاد هو نفسه يعرف إجابةً لسؤاله لماذا عاد لأرض الأجداد؟ الفردوس القديم الذي ولت أمجاده, وإن كانت هذه غفوة أم تهاويم لحظة شاردة, فحياته كابوس رازح, وهو ينادي من يلهو به أن ينهي هذا العذاب من تناوب الحمى والغيبوبة بعدما فتك به السرطان وأصبح جسده مهيضًا آخذًا في التحلل ويحتاج لمن يساعده, متوقعًا الختام ليلحق بأسلافه المقهورين.
يرسم لنا الكاتب صورًا عديدةً للفراديس التي كابد السارد طوال حياته لفقدها, وفاقم ذلك من مأساته, وظل الحنين يعتصره إليها. أم السارد هي أول هذه الفراديس؛ فبعد وفاة زوجها باخوم, الذي لا نكاد نعرف عنه شيئًا سوى عودة جثمانه في وقت متزامن مع ثورة 23 يوليو 1952, واضطرارها هي وطفليها عزيز ورمزي للإقامة في كنف الجد زارع بك, ولكنها سرعان ما تقرر الزواج من رجل يُمَثِّلُ المرحلة الجديدة بصلاته المتعددة مع ذوي الشأن ثم رحيلها معه إلى الغرب الأمريكي. السارد رغم صغر سنه يشتم رائحة السوس في زوج الأم, وغيرته الطفولية تتزايد. فهو يتمنى أن ينال المنزلة الأولى لدى أمه, وكان يغضبه أن يقصيه الكبار بعيدًا عن سهراتهم التي كانت أمه ملكتها المتوجة ويفيض بهاؤها على الكل إلا هو البعيد عن نعيمها. وبعد قرار زواجها يتمسك بالبقاء مع جده وعمته غيظًا وانتقامًا منها ومن زوجها. تتعذب نفسه الغضة من تساؤلات الكبار عن مدى محبته لأمه وواجبه ألا ينكر عليها حقها في مواصلة حياتها.
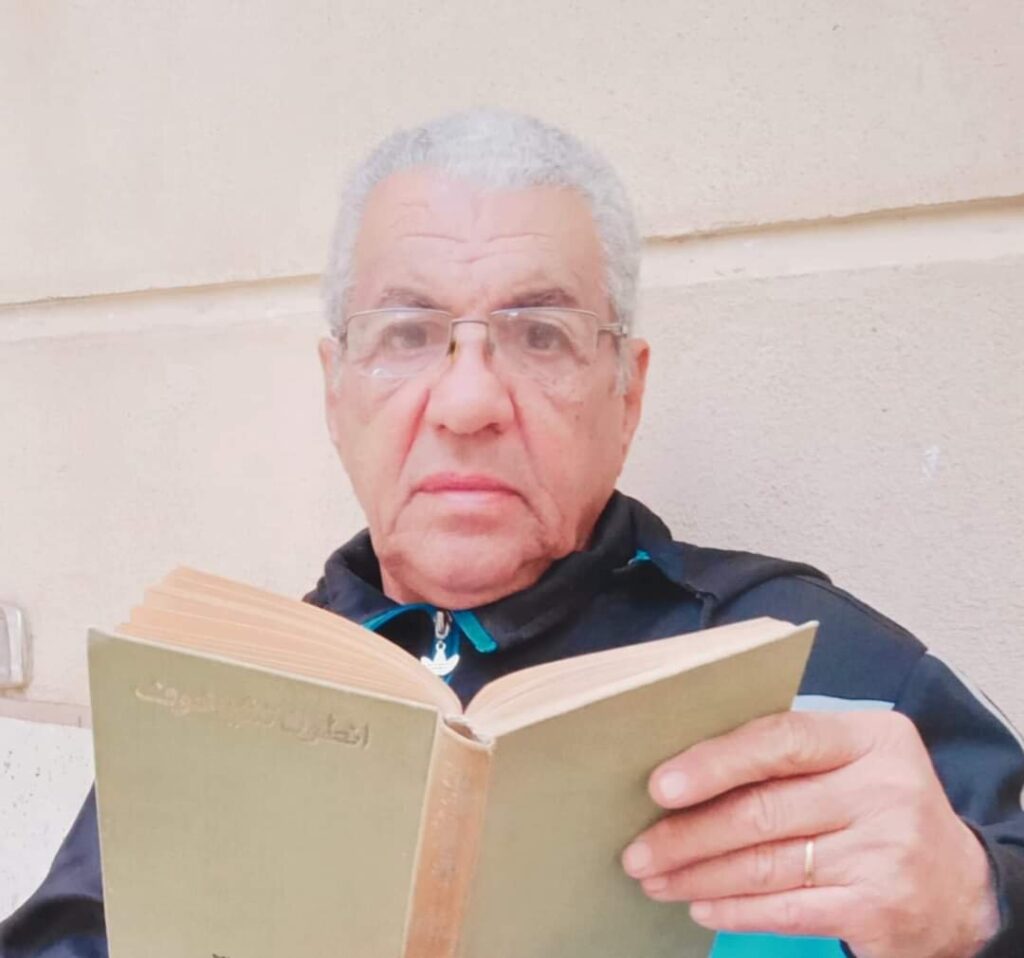
أما الفردوس الثاني المفتقد فيتمثل في فاطمة رفيقة صباه وحبه الكبير, ولكن هذا الحب لا يكتمل لاختلاف الدين بينهما, وسريان الشائعات والتلاسن من الخدم على أمور تخص سادتهم وما كان لهم التدخل لولا نقطة الاختلاف الديني. تتصاعد الأزمة في هجوم الموتورين على السرايا وهم أنفسهم من يطالبون بعد ذلك بتغيير اسم المدرسة التي أسسها الجد في العام 1935 كأن اسم العائلة العريقة قد صار معيبًا, واضطرار فاطمة للزواج والرحيل عن مصر إلى الخليج, فيكتشف طرفا الحب الذابل أن عليهما ألا يجلبا عارًا لأسرتيهما وألا يكونا سببًا في بناء سعادتهما الشخصية على تعاسة غيرهما.
وأخيرًا فثالث هذه الفراديس تجسده الإقطاعية التي أسسها الجد. فالسارد يقارن بين ما انتهت إليه من بقايا وحطام وما كانت عليه من أبهة وعظمة. إذ كان زارع بك في دخيلة نفسه لا يريد الاعتراف بحقيقة الموت وحتمية انحلال العناصر, راغبًا في الخلود في عالم تفنى كل مكوناته, ولم يعترف بحقيقة موت ابنه باخوم واحتجب عن المشهد, انزعاجه من موت حصانه الأثير “رخش” وما مَثَّلَهُ من فاجعة كبيرة. كان زارع بك يود أن تكون منزلته لدى الرب مستمدة من مقامه ونبل محتده وليست كتلك التي ينالها الإخوة الفقراء والبسطاء كهبة سماوية, بل وكان يهزأ ويسخر من ابنته منرفا ويطلق عليها لقب “سيدة الرحمة” لرعايتها بالفقراء والمرضى والمشردين, وكان يعتبر أن جيش خلاصها ذلك لم يجلب له سوى الوقوع في مشاكل جمة. والأغرب أن ابنه ميخائيل الذي نال تعليمًا راقيًا يتأثر بالأفكار الشيوعية ويرغب في توزيع الأراضي على الفلاحين, ولكن هذه الاعتقادات تجعل منه هدفًا لمطاردة البوليس السياسي, بل ويجني السارد جريرة عمه ويتعرض للاعتقال أيضًا دون ذنب.
فعودة السارد في نهاية أيامه هي جزء من عملية فناء هذه الإقطاعية العظيمة التي ترمز للكون ككل. ما اشتمه من فساد وتحلل في زوج الأم في الماضي, ها هو قد نخر جسده في النهاية بل وكتب السطور الأخيرة للإقطاعية وتاريخ ذويها. في هذيانه يظهر له عذاب الجحيم تارةً ثم تتجلى أمجاد الفردوس القادم تارةً, عباراته التي يرددها لذاته هي خليط من سرديات الطقوس الجنائزية في مصر القديمة مع صلوات الكنيسة القبطية لأجل الراحلين, بل وبعض المقاطع تتخذ لنفسها نفس وزن ونظم بعض الأجزاء من أسفار المزامير والرؤيا في الكتاب المقدس, وساعات احتضاره في يوم الجمعة الحزينة تتوازى مع آلام المسيح المصلوب. لدرجة أن القارئ يندهش أمام ما يطالعه في مأساة عزيز باخوم زارع, ويتساءل هل يرويها الطفل اليانع أم الكهل المحتضر؟ أهي اجترار الطفل المطرود من فراديسه لذكرياته المريرة المطمورة وأحزان الطفولة التي لا تُنْسَى, أم هي الهزائم التي توالت على رجل مريض بلا وظيفة ثابتة ولا مستقبل ولم يعد له من مأوى سوى ما تبقى في سرايا العائلة تعوله الخادمة سند والممرضة جنات؟
كل هذه الدوائر المتشابكة من ابتزاز المشاعر وتبرير الذات ونفي الأنانية عن النفس يتسم بها الجميع وإن كانوا ينكرونها, في مواجهة الأسئلة الحائرة عن علة الوجود وغاية الحياة وهل يعوضنا العالم الآخر عما كابدناه في عالمنا, تلتحم في هذه الرواية التي يصدق عليها وصف كاتبها أنها قد لا تعطي نفسها بسهولة ولعل الصبر الذي تتطلبه من قارئ محب يوازي الصبر الذي تخلقت فيه بين يديه.







