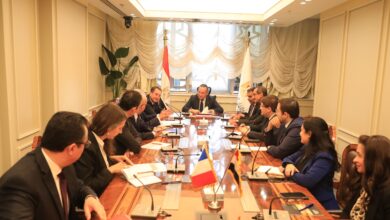جامعة حلوان الأهلية تعلن بدء التواصل مع الطلاب الجدد لاستقبال ملفات القبول
جامعة حلوان الأهلية تعلن بدء التواصل مع الطلاب الجدد لاستقبال ملفات القبول
أعلنت الجامعة عن بدء التواصل مع الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالجامعة من خلال لينك التسجيل المخصص، حيث سيتم إرسال رسالة تفصيلية لكل طالب عبر البريد الإلكتروني أو من خلال منصة التسجيل، تتضمن جميع معلومات وإرشادات عملية التقديم.
وأكدت الجامعة أن الرسالة ستشمل موعد تسليم الملف ورقم اللجنة الخاصة بكل طالب، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الواردة بها.وأوضحت الجامعة أن يوم الأحد المقبل سيكون اليوم الأول المخصص لاستقبال ملفات الطلاب المرشحين لكلية الطب البشري فقط، على أن يتم استقبال ملفات باقي الكليات في مواعيد محدده
كما أكدت الجامعة أنه لن يتم قبول أي ملف يتم تقديمه في يوم غير المحدد في الرسالة المرسلة للطالب، وذلك حرصًا على تنظيم عملية القبول وتسهيل الإجراءات لجميع المتقدمين.
ودعت جامعة حلوان الأهلية جميع الطلاب إلى متابعة منصة التسجيل باستمرار للاطلاع على الرسائل المرسلة، والالتزام بكل التعليمات لضمان استكمال عملية القبول بسهولة ويسر